
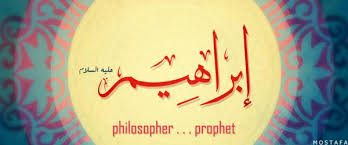
إن دعوة الله يجب أن تصل إلى آذان وقلوب كل البشر، غنيهم وفقيرهم،عامتهم وخاصتهم، الفقراء منهم والأغنياء، والعامة والرؤساء، مهما كان حجم التضحيات التي يبذلها الداعية إلى الله الذي يسير على نهج الأنبياء والمرسلين.
وها نحن نرى نبي الله إبراهيم - عليه السلام - يصدح بدعوته في وجه واحد من جبابرة الأرض حينذاك، يُسمعه كلام الله، ويُقيم عليه الحجة البينة الواضحة، ويُجادله بالتي هي أحسن.
لقد سجل القرآن الكريم هذا المعلم الهام من معالم التوحيد في دعوة إبراهيم - عليه السلام - وهو يحاجّ الجاحد المكذب المسمى النمروذ، فقال تعالى:
}أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{[البقرة:258].
تحكي الآية حوارًا بين إبراهيم - عليه السلام - وملك في أيامه يجادله في اللّه، ويعرض هذا الحوار على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته في أسلوب التعجيب من هذا المجادل الذي حاج إبراهيم - عليه السلام - في ربه، وكأنما مشهد الحوار يعاد عرضه من ثنايا التعبير القرآني العجيب!
فهذا الذي حاج إبراهيم - عليه السلام - في ربه هو ملك بابل نُمرُوذ بن كنعان، وهو واحد من بين أربعة ملكوا الدنيا مشارقها ومغاربها، وقد ذكر السُّدِّيُّ أنَّ هذه المناظرة كانت بين إبراهيم - عليه السلام - والنُّمْرُوذ بعد خروج إبراهيم - عليه السلام - من النار التي ألقاه فيها قومه، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة.
وأنكر نُمروذ أن يكون ثم إله غيره، وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره، وطول مدته في الملك؛ وذلك أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه (فيما قيل)؛ ولهذا قال: {أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ}.
فهو ينكر ويتعنت للسبب الذي كان ينبغي من أجله أن يشكر ويؤمن.. هذا السبب هو: }أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ{ .. جعل في يده السلطان!
لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف بفضل الله ونعمته، لولا أن الملك يطغي ويبطر من لا يقدِّرون نعمة اللّه، ولا يُدركون مصدر الإنعام، ومن ثم يضعون الكفر في موضع الشكر، ويَضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين!
وطلب هذا المتكبر من إبراهيم – عليه السلام - دليلًا على وجود الرب الذي يدعو إليه! فقال إبراهيم - عليه السلام -: {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ} أي: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها، وعدمها بعد وجودها.
وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له.
وخص إبراهيم - عليه السلام - الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير، ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا، والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة، وهما الظاهرتان المكرورتان في كل لحظة، المعروضتان لحس الإنسان وعقله.
وهما - في الوقت نفسه - السر الذي يحير، والذي يلجىء الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخر غير بشري، ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذي يعجز عنه كل الأحياء.
إننا لا نعرف شيئًا عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة، ولكننا ندرك مظاهرهما في الأحياء والأموات، ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى التي نعرفها على الإطلاق .. قوة اللّه الخالق المدبر.
وتأمل أن إبراهيم - عليه السلام - لم يدخل في أية مناقشات جدلية، بل المناقشة والحوار حول شيء واحد فقط هو التوحيد، والاستدلال عليه إنما يكون بالآيات المشاهدة التي يراها كل إنسان بأم عينيه، خطاب يوقظ الفطرة، ويأخذ بيديها إلى طريق الهداية، وهي الطريقة البارعة التي نجدها في الدعوة إلى التوحيد عند كل الأنبياء والمرسلين.
فعند ذلك قال النمروذ: {أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ{، وذلك أنه - فيما قيل - أمر برجلين قد استحقا القتل فأمر بقتل أحدهما فقتل، وبالعفو عن الآخر فلم يُقتل، فذلك معنى الإحياء والإماتة عنده.
لقد أراد أن يدَّعِيَ لنفسه هذا المقام عنادًا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يُحيي ويميت! وهو لم يدع الاستقلال بالتصرف، وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه، فزعم أنه يقتل شخصًا فيكون قد أماته، ويستبقي شخصًا فيكون قد أحياه!
ويبدو أن هذا الملك الذي حاج إبراهيم - عليه السلام - في ربه لم يكن منكرًا لوجود اللّه أصلًا إنما كان منكرًا لوحدانيته في الألوهية والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما يجري فيه وحده، كما كان بعض الكافرين في الجاهلية يعترفون بوجود اللّه لكنهم يجعلون له أندادًا ينسبون إليها فاعلية وعملًا في حياتهم!
وليس فيما قاله جوابًا لما قال إبراهيم - عليه السلام - ولا في معناه؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع - سبحانه وتعالى - ولذا لما رآه إبراهيم - عليه السلام - يغالط في مجادلته، ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة - فضلًا عن كونه حجة - اطرد معه في الدليل، وعدل عن طريقة العرض المجرد للسنة الكونية والصفة الإلهية إلى طريقة التحدي، وطلب تغيير سنة اللّه لمن ينكر، ويتعنت ويجادل في اللّه.
فقال لَمّا ادعى هذه المكابرة:
{فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ}
أي: إذا كنت كما تدعي أنك تحيي وتميت فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود، في خلق ذواته، وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلهًا كما ادعيت تحيي وتميت فأت بها من المغرب.
وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقًا في دعواه، فلما قال له أمرًا لا قوة له في شبهة تشوش دليله، عجز وانقطع، وعلم أنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام }فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ{، أي: أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة، وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه، فإنه مغلوب مقهور.
وكان التسليم أولى، والإيمان أجدر، لكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر، فيبهت ويبلس ويتحير، ولا يهديه اللّه إلى الحق لأنه لم يتلمس الهداية، ولم يرغب في الحق ولم يلتزم القصد والعدل.
}وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ{ أي: لا يلهمهم حجة ولا برهانًا، بل حجتهم داحضة عند ربهم، إذ يبقيهم على كفرهم وضلالهم، وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك، وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه.
ففي الحوار برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير، ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع الأحوال.