
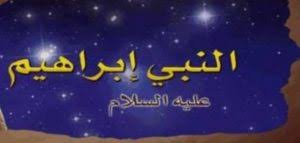
قال الله تعالى:
}قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ {[الممتحنة:4].
يتجلى في هذه الآية وغيرها من الآيات الكريمات معلم رئيس من معالم التوحيد في دعوة إبراهيم عليه السلام، ألا وهو البراءة من معبودات المشركين الباطلة، وكذلك البراءة من المشركين وأفعالهم الشركية.
يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمقاطعة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبرؤ منهم: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{ أي: قدوة صالحة وائتمام ينفعكم وخصلةٌ حميدةٌ حقيقةٌ بأنْ يُؤتَسَى ويُقْتَدى بهَا.
}فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} أي: وأتباعه الذين آمنوا معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم - عليه السلام - حنيفًا.
{إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ} أي: إذ تبرأ إبراهيم - عليه السلام - ومن معه من المؤمنين، من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله.
{وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ} أي: بدينكم وطريقكم.
{وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا} يعني: وقد شرعت العداوة والبغضاء، والبغض بالقلوب، والعداوة بالأبدان، من الآن بيننا وبينكم، فليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد بل ذلك {أَبَدًا} ما دمتم على كفركم، فنحن أبدًا نتبرأ منكم ونبغضكم، وصرحوا بعداوتهم غاية التصريح.
{حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ} أي: هَذا دأبُنَا معكُم لا نتركُهُ إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان.
فالتأسي هنا في ثلاثة أمور:
أولًا: التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله.
ثانيًا: الكفر بهم.
ثالثًا: إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدًا إلى الغاية المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده، وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدًا، والسبب في ذلك هو الكفر، فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم.
{إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} أي: لكم في إبراهيم - عليه السلام - وقومه أسوة حسنة تتأسون بها في القيام بالإيمان والتوحيد، والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده، إلا في استغفار إبراهيم - عليه السلام - لأبيه، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم، ويقولون: إن إبراهيم - عليه السلام - كان يستغفر لأبيه.
فإنَّ استغفارِه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لأبيهِ الكافرِ وإنْ كانَ جائزًا عقلًا وشرعًا لوقوعِهِ قبل تبينِ أنَّهُ من أصحابِ الجحيمِ كما نطقَ به النصُّ لكنَّهُ ليسَ ممَّا ينبغِي أنْ يُؤتسى بهِ أصلًا إذ المرادُ بهِ ما يجبُ الائتساءُ بهِ حتمًا لورودِ الوعيدِ على الإعراضِ عنه كما في قولِه تعالى: }وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ{ [الحديد:24]، فاستثناؤهُ من الأسوةِ إنما يفيدُ عدمَ وجوبِ استدعاءِ الإيمانِ والمغفرةِ للكافرِ المرجوِّ إيمانُهُ.
وموضع التأسي المطلوب في إبراهيم - عليه السلام - هو ما قاله مع قومه المتقدم جملة، وما فصله تعالى في مواضع آخرى منها:
}فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (*) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ{ [ الأنعام:78-79].
}وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا{ [مريم:48].
}قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (*) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (*) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ{ [الشعراء:75-77].
}وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (*) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ{ [الزخرف:26-27].
وقد جاء ما يدل على أنها قضية عامة وليست خاصة في إبراهيم - عليه السلام - كما في قوله تعالى:}مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ{ [التوبة:113]، وفي هذه الآية وما قبلها أقوى دليل على أن دين الإسلام ليست فيه تبعية أحد لأحد، بل كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
ومن عجب أن يأتي نظير موقف إبراهيم - عليه السلام - من أبيه مواقف مماثلة في أمم متعددة، منها موقف نوح - عليه السلام - من ابنه لما قال: }وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ{ [هود:45] ، فلما تبين له أمره أيضًا من قوله تعالى: }قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ{ [هود:46] }قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ{ [هود:47] ، فكان موقف نوح - عليه السلام - من ولده كموقف إبراهيم - عليه السلام - من أبيه، ومنها: موقف نوح ولوط - عليهما السلام - من أزواجهما، وموقف زوجة فرعون - رضي الله عنها - من فرعون.
إن هذه الآية القرآنية الكريمة التي ترسم معلم البراءة من المشركين بوضوح شديد تصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة: أمة التوحيد، وهذه القافلة الواحدة: قافلة الإيمان، الممتدة في الزمان، المتميزة بالإيمان، المتبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيدة.
إنها الأمة الممتدة منذ إبراهيم - عليه السلام - أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى، وفيه أسوة لا في العقيدة وحدها، بل كذلك في السيرة، وفي التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ثم خلص منها هو ومن آمن معه، وتجرد لعقيدته وحدها.
فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم، وهو الكفر بهم والإيمان باللّه، وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم باللّه وحده، وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئًا من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان، وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي يمر بها المؤمن في أي جيل، وفي قرار إبراهيم - عليه السلام - والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين.