
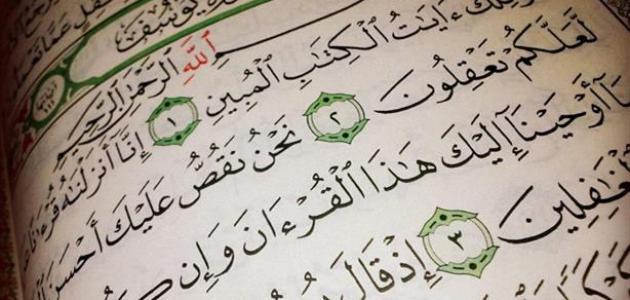
تبدو معالم التوحيد في دعوة يوسف - عليه السلام - من خلال حواره مع صاحبَيْه في السجن، حيث استغل يوسف - عليه السلام - المحنة والابتلاء والمُكث الطويل في سجنه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
ولم يكن - عليه السلام - إلا سائرًا على نهج الأنبياء من قبله، مبتدأ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ المعبودات الباطلة والآلهة المزعومة التي يعكف عليها عباد الأصنام والأوثان من قومه.
قال الله تعالى:
} قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ{ [يوسف: 37].
قال يوسف - عليه السلام - للرجلين:
} لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا{، أي: فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما، أو عشاؤكما، أول ما يجيء إليكما، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما.
والتّثبّت فى الجواب دون التسرع من أمارات أهل المكارم، كيوسف - عليه السلام - فقد وعدهما أن يجيبهما ولم يسرع الإجابة، وأخّر عنهما الإجابة وعلّق قلوبهما بالوعد الذي قطعه، وقدّم على الجواب ما اقترحه عليهما من كلمة التوحيد لأنها أنفع لهما من تأويل ما راوه، ولينزعهما عما هم فيه من عبادة الأوثان، وعبادتهما غير اللَّه، وليرغبهما في توحيد اللَّه، وصرف العبادة إليه.
فيوسف - عليه الصلاة والسلام - قَصَدَ هنا أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه، ليكون أنجع لدعوته، وأقبل لهما.
فعلى كل ذي علم من دعاة التوحيد إذا احتاج إلى سؤاله أحد أن يقدم على جوابه نصحه بما هو الأهم له، ويصف له نفسه بما يرغبه في قبول علمه إن كان الحال محتاجًا إلى ذلك، ولا يكون ذلك من باب التزكية بل من الإرشاد إلى الإئتمام به بما يقرب إلى الله فيكون له مثل أجره.
ثم قال: {ذَلِكُمَا} التعبير الذي سأعبره لكما {مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي} أي: لست أخبركما على جهة التَّكهُّن والتَّنجُّم، وإنَّما ذلك بوحي من الله - عز وجل - وعلمٍ، وفيه إشعار بأن له علومًا جمة وأنه يعرف ذلك وأدق منه، ليقبلا نصحه فيما هو أهم المهم لكل أحد، وهو ما خلق العباد له من الاجتماع على الله، وانتهازًا لفرصة النصيحة عند هذا الإذعان بأعظم ما يكون النصح به من الأمر بالإخلاص في عبادة الخالق والإعراض عن الشرك.
ثمَّ أخبر عن إيمانه واجتنابه الكفر، فقال: {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.
أي: والسبب في هذا العلم والوحي هو أنني هجرت طريق الكفر والشرك واجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر، فلا يرجون ثوابًا ولا عقابًا في المعاد.
واشار بهذا إلى القوم الذين رُبي فيهم، وهم بيت العزيز، وحاشية الملك، والملأ من القوم، والشعب الذي يتبعهم، والفتيان على دين القوم، ولكنه لا يواجههما بشخصيتهما، إنما يواجه القوم عامة كي لا يحرجهما ولا ينفرهما، وهي كياسة وحكمة ولطافة حس وحسن مدخل.
فكأنه قيل: لماذا عَلَّمَكَ رَبُّكَ تلك العلوم البديعة؟ فقيل: لأني تركتُ مِلَّةَ الكفرة أي دينهم الذي اجتمعوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان.
وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى، واتبع طريق المرسلين، وأعرض عن طريق الضالين، فإن الله يهدي قلبه، ويعلمه ما لم يكن يعلم، ويجعله إمامًا يقتدى به في الخير، وداعيًا إلى سبيل الرشاد.
والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه، يكون لمن لم يدخل فيه أصلا. فلا يقال: إن يوسف - عليه السلام - كان من قبل، على غير ملة إبراهيم - عليه السلام - وهو كقوله تعالى: }رَفَعَ السَّمَاوَاتِ{، ليس أنها كانت موضوعة فرفعها، ولكن رفعها أول ما خلقها.
فالمراد بتركها الامتناع عنها رأسًا كما يفصح عنه قوله تعالى: } مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ{ لا تركها بعد ملابستها، وإنما عبر عنه بذلك لكونه أدخل بحسب الظاهر في اقتدائهما به - عليه السلام -، والتعبير عن كفرهم بالله تعالى بسلب الإيمان به للتنصيص على أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الأوثان ليست بإيمان به تعالى.
{وهم بالآخرة} وما فيها من الجزاء {هم كافرون} على الخصوص دون غيرهم لإفراطهم في الكفر.
وذِكر الآخرة هنا في قول يوسف - عليه السلام - يقرر أن الإيمان بالآخرة كان عنصرًا من عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعًا منذ فجر البشرية الأول ولم يكن الأمر كما يزعم جهال العصر أن تصور الآخرة جاء إلى العقيدة متأخرا!
نعم! لقد جاء إلى العقائد الوثنية الجاهلية متأخرًا فعلًا، ولكنه كان دائمًا عنصرًا أصيلًا في الرسالات السماوية الصحيحة.
وجاء كلامه مؤكدًا تأكيدًا عظيمًا، إشارة إلى أن أمرهم ينبغي أن ينكره كل من يسمعه، ولا يصدقه، لما على الآخرة من الدلائل الواضحة جدًا الموجبة لئلا يكذب به أحد.